يُعدّ كتاب والتر أونغ «Orality and Literacy» (1982) أحد النصوص التأسيسية في دراسات الثقافة والمعرفة، إذ يقدّم تصورًا بالغ التأثير لكيفية انتقال المجتمعات من أنساق الذاكرة الشفوية إلى تقنيات التدوين والكتابة، ثم الطباعة والإعلام الإلكتروني. لا يكتفي أونغ بوصف تحوّل وسائط التعبير، بل يربط بين الوسيط وأشكال الوعي؛ فاللغة هنا ليست مجرّد أداة، بل بيئة تُشكِّل التفكير ذاته وتعيد توزيع قدراته وحدوده.
ينطلق أونغ من التمييز
بين «الشفاهية الأولية»، أي المجتمعات التي لم تعرف الكتابة قط، و»الثقافات الشفوية
الثانوية» التي تولّدت في العصر الإلكتروني؛ حيث تُستعاد خصائص الإنشاد والحفظ والإيقاع
عبر الراديو والتلفزيون والمنصات السمعية-البصرية، ولكن على أرضية كتابية/طباعية سابقة.
في المجتمعات الشفوية الأولى، للفكر قوانينه: يميل الخطاب إلى «التراكم والإضافة» بدل
التفريع المنطقي، وإلى «الصيغ الجاهزة» والأمثال والتكرار حفاظًا على الذاكرة الجمعية.
تتغذّى اللغة من سياقها الحيّ، وتبقى المعاني مشدودة إلى الأداء والموقف والمخاطَب
الحاضر. لذلك يصف أونغ “سيكوديناميات الشفاهية” بأنها «قريبة من الجسد»، تعتزّ بالمواجهة
والجدل، وتفضّل الحِجاج القائم على القوة الأدائية والذاكرة الإيقاعية.
في المقابل، تُحدث
الكتابة—ثم الطباعة—»ثورة هادئة في بنية الوعي». فهي تفصل الكلام عن قائله وعن ظرفه،
وتُشيّئ اللغة في أثرٍ بصريّ قابل للفحص والمراجعة المقارنة. هنا يظهر «التجريد»، وتتقوّى
«الذاتية الداخلية» بفعل القراءة الصامتة، ويغدو التفكير أكثر ميلًا إلى التصنيف، والسببية،
وبناء الحجّة الخطية. بهذا المعنى، لا تعدّ الكتابة مجرّد “اختراع” ضمن اختراعات؛ إنها
«تقنية للذهن» تعيد هيكلة طرق التذكّر والتخيّل والاستدلال. والطباعة تضاعف هذا الأثر
بتوحيد النصوص وتوسيع الجمهور وإرساء معيار لغوي ومعرفي مستقر؛ ما يفسّر، في منظور
أونغ، الصلة العميقة بين انتشار الطباعة ونشوء العلم الحديث والمدرسة والبيروقراطية.
قيمة هذا الكتاب لا
تكمن في الثنائيات المريحة بين شفاهي/كتابي فحسب، بل في «التدرّج التاريخي والتراكب»
بين الوسائط. فحتى أكثر الثقافات كتابةً لا تنفصل عن موارد شفاهية: الخطابة، الحوار،
الإلقاء، والتواصل اليومي. كما أن الوسائط الإلكترونية الحديثة، على حدّ تعبير أونغ،
تُعيد إلينا “شفاهية ثانوية” تتقاطع فيها «حميمية الصوت الحيّ» مع «قابلية إعادة الإنتاج»
التي تتيحها التقنيات. ويستشهد الباحث بأمثلة من الإعلام الأميركي ومن دراسة الحركات
الدينية والمنابر الجماهيرية التي تستخدم الخطاب السمعي-البصري لتكوين مجتمع تخييلي
متزامن.
مع ذلك، لا يخلو طرح
أونغ من نقاط تحتاج إلى نقاش. فقد أُخذ عليه أحيانًا «النزوع الحتمي-التقني»: أي إغراء
ردّ الفعل الثقافي إلى الوسيط وحده. انتقده باحثون مثل جاك غودي وديفيد أولسون على
«التعميم الواسع» بشأن ما “تفعله” الكتابة أو الطباعة بالعقل، واقترحوا نظرة أكثر التفافًا
على دور المدرسة والمؤسسات والسياقات الاجتماعية في تشكيل مخرجات المعرفة. كما أشار
بعض الأنثروبولوجيين إلى أن «الشفاهيات متعدّدة»، وأنها قد تُنتج تفكيرًا تحليليًا
متينًا ضمن شروطها. ومع ذلك، فإن أونغ نفسه يلمّح إلى هذه التحفّظات عندما يصرّ على
أن الشفاهية والكتابية «طيفٌ» يتعالق فيه الصوت والنصّ بلا قطيعة نهائية.
أسلوبيًا، يكتب أونغ
بوضوح مدرّب يزاوج بين «التحليل التاريخي» و»أمثلة لغوية وسوسيولوجية»، ويستند—ضمنيًا
وصريحًا—إلى إرث أستاذه مارشال ماكلوهان في فكرة أن «الوسيط رسالة»؛ أي أنه بنية تُعيد
تكوين المجتمع الذي يتبنّاها. غير أن أونغ ينأى عن الحِدّة الاستفزازية لدى ماكلوهان،
فيقدّم أطروحته بلغة متوازنة وبشواهد تعليمية تُسعف القارئ غير المتخصص.
أهمية الكتاب اليوم
مضاعفة. فمع صعود المنصات القصيرة الفيديو والبودكاست، نشهد ما يسمّيه أونغ “عودة الصوت”
في شروط رقمية: «سوق انتباه» يحكمه الإيقاع والالتقاط الفوري للمعنى، وتغذية راجعة
لحظية تُعيد الاعتبار للخطابة والأداء. لكن هذه العودة لا تُبطل أثر الكتابة؛ بل تدفع
إلى «هجنات» جديدة: نصوص تُكتب لتُسمع، وخطابات تُؤرشف لتُقرأ لاحقًا. هنا تتبدّى حدّة
سؤال أونغ: كيف يؤثّر الوسيط في «معايير الحقيقة والإقناع»؟ إذا كان النص يسمح بالتدقيق
والإحالة والتراكم الأكاديمي، فإن الصوت يعزّز «الثقة الكاريزمية» والعدوى الوجدانية.
على صانع المعرفة المعاصر أن يعي هذا التواشج، وأن يبني خطابًا يوفّق بين «صرامة الكتابة»
و»حيوية الأداء».
على الصعيد التعليمي،
يوفّر الكتاب أدواتٍ لفهم سلوك المتعلّمين بين «قراءة مطوّلة» و»تعلّم سمعي-بصري».
فبدل اعتبار الوسائط الجديدة تهديدًا، يدعو منظور أونغ إلى توظيف خصائصها: استعمال
الإيقاع والسرد الشفاهي لفتح أبواب الفهم، ثم توجيه المتعلّم إلى مهارات التثبيت النصي
والتحليل المقارن. بهذا، تصبح “الشفاهية الثانوية” موردًا تربويًا لا نقيضًا لثقافة
الكتاب.
خلاصة القول: «الشفاهية
والكتابية» كتاب صغير الحجم، عميق الأثر. ميزته أنه لا يقدّم «نوستالجيا للصوت» ولا
«وثنيّة للنص»، بل يعلّمنا الإصغاء إلى ما يفعله «الوسيط بعقولنا» قبل لغاتنا. ورغم
التحفّظات النقدية المشروعة على بعض تعميماته، يبقى نصًّا مرجعيًا لفهم ما يحدث حين
تتحوّل الأدوات من فمٍ ينشد إلى عينٍ تقرأ، ثم إلى شاشةٍ تُشاهد وتُكتب في آنٍ واحد.
إنّه، في جوهره، درسٌ في تواضع المعرفة: فكلّ وسائطنا «تفتح نوافذ» وتغلق أخرى، وعلى
الدارس أن يتحرّك بينها بوعي يقظ، كي لا يغدو أسيرًا لصوتٍ واحد، أو لسطرٍ واحد.







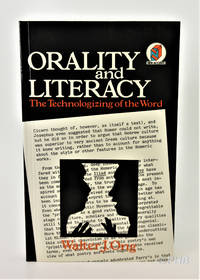





0 التعليقات:
إرسال تعليق