في السنوات الأخيرة صار المشهد الإعلامي أشبه بغرفةٍ مُغلقة تضجّ بأصوات الأجهزة نفسها التي نناقش آثارها. الشاشات تضيء، الهواتف تُرنّ، والتدفّق اللانهائي للبيانات يخلق ما يشبه الغبار الرقمي الذي يستقرّ في وعينا من غير أن ننتبه. وسط هذا الضجيج تبرز الصحافة، لا بصفتها وسيطاً لنقل الخبر فحسب، بل كجهازٍ تشخيصي يُعيد قياس نبض علاقتنا بالتكنولوجيا وبما تخلّفه وراءها من نفايات إلكترونية وتلوّث طاقي لا يقلّ خطورة عن مخلفات المصانع التقليدية. إن الحديث عن “النفايات الإلكترونية” لم يعد محصوراً في تقارير بيئية أو دراسات تقنية، بل صار جزءاً من سؤالٍ أكبر حول استدامة العالم الرقمي الذي نعيش فيه.
في مطلع العقد الماضي نبهت تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أنّ العالم ينتج سنوياً نحو 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية، أغلبها يُهرّب إلى بلدان الجنوب حيث تُحرق المكوّنات البلاستيكية والمعادن الثقيلة في مكبّات مفتوحة. غير أن دور الصحافة في كشف هذه الرحلة القاتمة كان محورياً، تماماً كما فعل الصحافي آدم مينتر في كتابه Junkyard Planet الذي تتبع فيه مسارات الخردة العالمية، مسلطاً الضوء على الاقتصاد الخفي لتجارة النفايات. مثل هذا العمل يؤكد أن الصحافة الاستقصائية لا تكتفي بفضح الأرقام، بل تُعيد ترتيب المشهد الأخلاقي بحيث يرى القارئ الصورة كاملة: الإنسان، والآلة، والبيئة، وكلفة التقدّم.
لكن ما يضفي على المسألة تعقيداً إضافياً هو أنّ الصحافة نفسها أصبحت جزءاً من المشكلة. فغرف الأخبار الرقمية تستهلك كميات هائلة من الطاقة، والمنصات التي تبث محتواها تعتمد على مراكز بيانات تلتهم الكهرباء كوحوش جائعة. تقرير نشرته The Guardian عام 2023 أشار إلى أن نسبة معتبرة من البصمة الكربونية العالمية باتت مرتبطة بالبنية التحتية للإنترنت. وهذا التحول يضع الصحافة أمام سؤال وجودي: كيف يمكن لوسيطٍ يساهم في التلوّث الرقمي أن يقود حملة عالمية لتقليصه؟ هنا يبرز ما يمكن تسميته “أخلاقيات الأثر الرقمي”، وهي مقاربة جديدة تدعو غرف الأخبار إلى مراجعة ممارساتها، سواء عبر تقليل مواد الفيديو غير الضرورية، أو تحسين خوارزميات البث، أو اعتماد بروتوكولات أكثر استدامة في تخزين البيانات.
ورغم ذلك، يبقى دور الصحافة أساسياً في صياغة وعي عام يقاوم هذا التدهور البيئي الصامت. فمن خلال تقارير DW أو سلسلة التحقيقات التي نشرتها Wired حول النفايات الإلكترونية في نيجيريا وغانا، برزت قدرة الإعلام على ربط القارئ بصور ملموسة: أطفال يفتّشون بين الأسلاك المحروقة، عمال يُفرزون معادن سامة بأيديهم العارية، وقرى تتنفس دخان الرقاقات المحترقة. لم تكن تلك الصور ترفاً جمالياً، بل أدوات معرفية تُقوّي الحجة وتُشعل الخيال الأخلاقي الذي تحتاجه المجتمعات لتغيير سلوكها.
إلى جانب الصورة، تلعب السردية الصحفية دوراً لا يقلّ أهمية. فكلما نجح الصحافي في تحويل البيانات الجافة إلى قصص نابضة، أصبح القارئ أكثر استعداداً للتفاعل. يشبّه بعض الباحثين هذا التحول بأسلوب راشيل كارسون في كتابها Silent Spring الذي أطلق ثورة بيئية في الستينيات من خلال نثرٍ علمي قادر على ملامسة الحسّ الإنساني. وبالطريقة نفسها، تتّجه الصحافة المعاصرة إلى صوغ حكايات حول دورة حياة جهاز الهاتف: من المعادن المستخرجة في الكونغو، إلى مصانع التجميع في آسيا، وصولاً إلى مقالب النفايات في إفريقيا. إنها حكاية تتجاوز الجغرافيا وتكشف وجهاً آخر من وجوه العولمة، أشبه بخيطٍ خفي يشدّ العالم نحو مصير مشترك.
غير أنّ التحدي الأكبر يظلّ في أن التقارير وحدها لا تكفي ما لم تُدرج أزمة النفايات الإلكترونية ضمن سياسات تشاركية تعتمد على الشفافية والضغط المجتمعي. هنا تتقاطع الصحافة مع أدوار أخرى للخطاب العام: حملات المجتمع المدني، الدراسات الأكاديمية، وتوصيات الهيئات الدولية. فالصحافة تسهم في بناء الجسر بين هذه الأطراف، وتُحوّل المعرفة المتخصصة إلى وعي جماهيري قادر على مساءلة الحكومات والشركات. وقد رأينا ذلك في أوروبا عقب تقارير صحفية كشفت سوء إدارة التخلص من الهواتف القديمة، إذ دفع الضغط الإعلامي المفوضية الأوروبية إلى مراجعة تشريعات الاقتصاد الدائري.
ومع هذا كلّه، يتضح أن أزمة النفايات الإلكترونية ليست مجرد مشكلة تقنية، بل هي سؤال عن الإنسان نفسه. فالعالم الذي ينتج تريليونات من البيانات كل ساعة يبدو كأنه يفرغ ذاكرته في محيطاتٍ من الأزرار والمخلفات، بينما البشر غارقون في سُباتٍ رقمي. وهنا تكتسب الصحافة دوراً شبيهاً بذاكرة بديلة، تذكّرنا بما نتركه خلفنا، وتحذّرنا من المستقبل الذي نصنعه بأيدينا. إنها، بشكل ما، تقوم بما يشبه التنقيب في “مقالب المستقبل”، إذ تستخرج منها الدلالات وتعيد تركيبها في لغة قادرة على الإقناع والتحريض.
إن مستقبل العلاقة بين الصحافة والتلوّث الرقمي سيعتمد على قدرة المؤسسات الإعلامية على إعادة بناء نماذج إنتاجها وخطابها في آن واحد. فكلّ خبرٍ يُنشر، وكلّ فيديو يُبث، وكلّ بايتٍ يُخزّن، يجب أن يكون جزءاً من مسؤولية بيئية أوسع. وبينما تتسارع وتيرة التحول الرقمي، تظلّ الصحافة مطالبة بأن توازن بين حاجتنا إلى المعرفة وبين حماية العالم من كلفة المعرفة نفسها. إنها مهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة إذا أُنجزت بروح نقدية، ورؤية أخلاقية، وإيمانٍ بأن للخبر قوة تُغيّر السلوك كما تُغيّر السياسات.
بهذا المعنى، لا تصبح الصحافة فقط مرآة لواقع ملوّث، بل تتحول إلى ضوءٍ صغير يتسلل داخل هذا الضباب الرقمي، معلناً أن العالم لا يزال قادراً على الإصغاء، وعلى التغيير، وعلى إنقاذ نفسه قبل أن يصبح الحاضر نفسه جزءاً من مكبّات الغد.







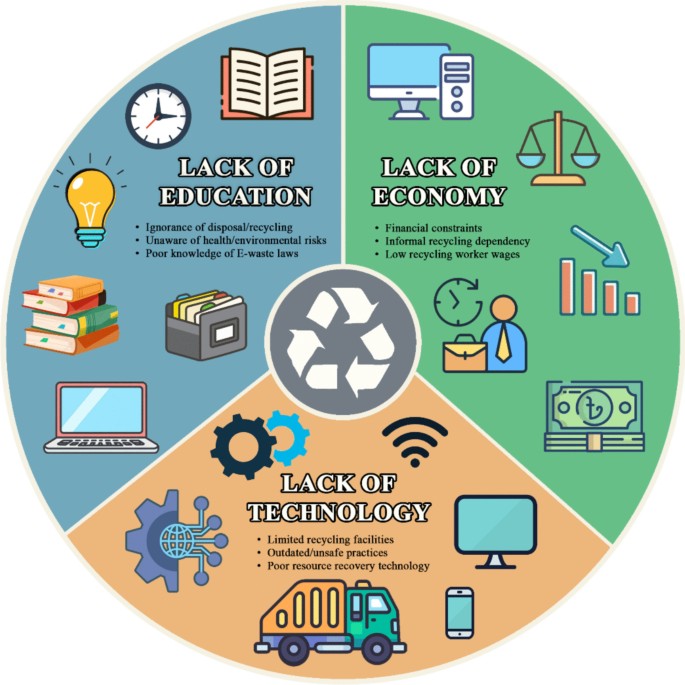







0 التعليقات:
إرسال تعليق